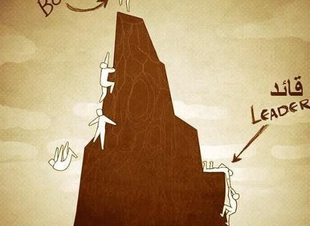أُسَرٌ افتراضية
الكاتب :عبدالعزيز الجاسم
تستوقفني تلك المشاهد التي يُعبَّر عنها بجملة "كان يا مكان"، مشاهد لأسر كانت تعيش في بيتٍ واحد، تنتظر عودة العائل مساءً لتقضي معه سويعاتِ ما قبل وجبة العشاء، تلك الأسر التي يستيقظ أفرادها مع صوت صياح الديك لتبتهل إلى بارئها ثم تغدو لمعاشاتها، الأبناء بثيابهم النظيفة، الفتيات بلباسهن المعطّر وشعرهن المجدول أو المربوط بأشرطةٍ زاهية، يسعون بنشاطٍ لتحصيل العلم في المدارس، الأب يودّع امرأته بابتسامة العاشق، فتردها له بابتسامة الرضا، كلّ يعمل حسب موقعه في الأسرة، فسواء كانت الأم عاملةً بوظيفة أم ارتضت أن يكون بيتها وظيفتها؛ يتكرر ذلك المشهد الذي نرى فيه الأم تحمل رضيعها الباسم الوديع محفزةً إياه لرفع يده مودعاً أباه وإخوته الماضون لشغلهم، يمضي النهار ويأتي وقت الرواح، يعود الجميع إلى المنزل سابقين لعائلهم الذي يكون آخر الوافدين من عمله، جدولٌ من النظام يجمع كل الأفراد على طاولة طعامٍ واحدة، مشاهدةٌ واحدة لشاشة التلفاز الذي ينقل طيف الأخبار تارةً، وحلقة المسلسل تارةً أخرى، ناهيك عن فقرة الرسوم المتحركة التي تسلب تركيز الأطفال وتنقلهم إلى عالمها البريء، "كان يا مكان"؛ أسرةٌ كهذه التحقتْ بما ندعوه "زمن الطيبين"، الزمن الذي لا يمكن أن يعود، زمنٌ رحل بكل تفاصيله ولم يترك على طاولة الحوار سوى الذكريات الجميلة والمؤلمة على حدٍّ سواء.
أغلقتُ صفحة هذه الذكرى فأقفلتُ تلك المشاهد التي قد يجد فيها بعضنا الكثير من المثالية، والعديد من صور المبالغة، لكني لن أبالغ حينما أنظر لأسر مشابهة يعيش أهلها عولمة اليوم، جلوس بملل، نهوض في عجالة، ذلك أشغل دورة المياه، وتلك نسيَتْ أين وضعت مشطها، حقيبة المدرسة على الأرض متناثرةً كتبها بجانب الطاولة، أسلاك قوابس الكهرباء لا تزال في وضع التشغيل، وشاشة كبيرةٌ مضاءةٌ بها صورةٌ جامدة للُعبةٍ قتاليةٍ توقّف عندها أحد الأبناء حين غزاه النوم، صراخٌ هنا، صيحاتٌ هناك، متأخرون على المدرسة –يعبرّ أحدهم– كما تشير أخرى لنقصٍ في أداء عملها المدرسي الذي لم تكمله والدتها؛ وربما تنال بسبب ذلك توبيخ المعلّمة، طفلٌ صغيرٌ منكبٌّ على وجهه في سريره الذي فاحت منه رائحة النوم وفضلات بطنه المكتنزة في وعاء من القطن يلبسه، لتختلط تلك الروائح ببقايا رائحة الحليب المجفف الذي -طفحَهُ- حسب تعبير والدته وهي تنادي على الخادمة الآسيوية التي بدورها تسير ببطءٍ زامةً شفتيها، ممتعضةً من هذا البيت ومَن فيه.
فضاء التكنولوجيا الواسع يحفّز كل مَن في الدار لاستقباله حين الرواح، فالجميع يهرع عائداً إلى المنزل بعد يومٍ حافلٍ من الدراسة والعمل، عودةٌ ليس بها شوقٌ لقبلةِ أمّ أو دعاء والد، إنما الهيام في التقاط الهاتف المحمول، وجهاز الألعاب الصغير والكبير والمتوسط الحجم والسعة التي وفّرها الأب بعد نجاح، أو أتتْ بها الأم في حفلة عيد ميلاد ربما، لا طاولة تجمع أحداً على وجبة، بل لا توقيت لتلك الوجبات التي ارتبطت بالتوصيل المباشر عبر تطبيقات طلبات الأطعمة، كما هي الألبسة والصداقة والعلاقات العامة، الاجتماعية منها والعملية، هدوءٌ يسكن تلك البيوت إلا من نقرات الأصابع على لوحات مفاتيح كتابة الأجهزة المحمولة، تلك اللوحات التي يتم إخراسها في بعض الأجهزة أيضا، سكونٌ يجعلك تستمع لصوت عقارب الساعات إن لم تطغَ على وجودها الساعات الرقمية، وربما دبيب النمل التي قد يأتي عليها يومٌ فتكون الكترونية أيضا، تنام بقايا البطاطا المقرمشة على طاولة الطعام، علب المشروبات الغازية وربما الطازجة المستهلَكة تملأ حاوية المطبخ إلا ما ترمي بها الخادمة -إن فعلَتْ-، عالمٌ مزدحمٌ بالطاقة السلبية، مكتظٌ بالأجهزة الإلكترونية، مليء بالشحنات التي تبات بجانب كل فردٍ في كل ليلةٍ لتشحن طاقته لليوم التالي كما تشحن طاقة جهازه الظل المحمول لتوصله لرقم مائة.
"كان يا مكان"، كنا عوائل تجمعنا الروابط الاجتماعية، فصرنا أسراً تربطنا أسلاك المقابس الكهربائية من الفئة الثالثة، ولا أدري هل أنّ لحياتنا الحالية ضمانٌ كالذي تحصل عليه أجهزتنا المحمولة والمكتبية وأجهزة الألعاب والمشاهدة؟ أم أننا سنقضي بقية حياتنا الرخيصة المحتوى، الافتراضية الوجود، السحابية المشاعر؛ دون ضمان!









.jpg)





.jpg)




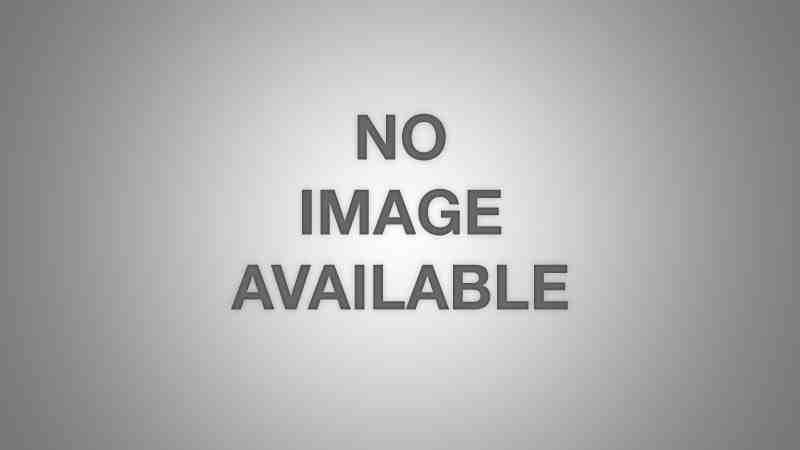















.jpg)












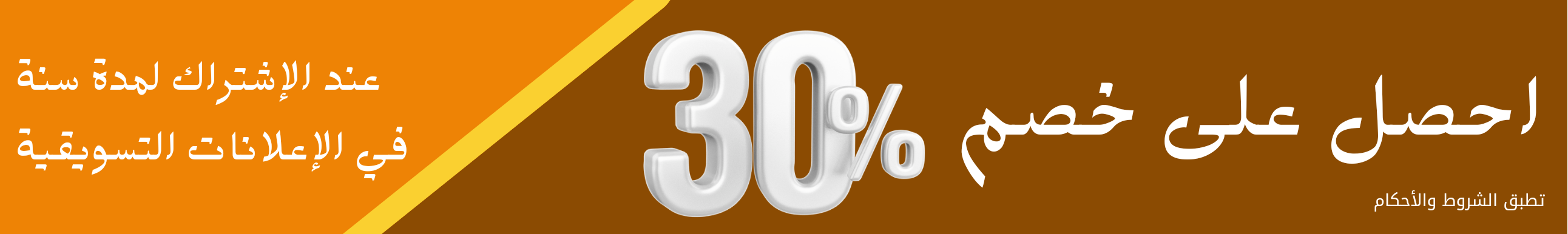








.jpg)